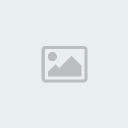كيف يفكر القلب؟
كثر الحديث في الحضارة الغربية المعاصرة عن العقل وعن المنطق، حتى أصبح الاعتماد عليه وعلى علومه العقلية والمنطقية هو المقياس الذي يقاس به تقدم الأفراد والشعوب والأمم في النهضة العلمية والصناعية والتقنية، بل وحتى في وجود ورقي المشاعر الإنسانية وعن دوره في رقي الإنسان ونهضته وتطوره، حتى كأن القلب غير موجود وأنه ليس له دور يذكر. همشوا قلوبهم والقلب هو الإنسان.
من الجانب المادي اهتموا بالعقل والمنطق، والعقل، كما هو متعارف عليه عالمياً، هو جهاز التفكير والتحليل عند الإنسان وهو المسؤول عن المنطق، ويقصد بالمنطق هنا حسن الفهم للمواضيع والاستشكال، ولا يقصد بالمنطق هنا النطق والكلام والتعبير، وإن كان النطق التعبير الصحيح هو المطلوب ولكن يقصد بالمنطق طريقة التفكير وطريقة ترتيب وتسلسل الأفكار والحجج والأدلة المناسبة التي يستشهد بها للإيضاح أو للاستنتاج أو لإثبات موضوع ما.
ولما اقتنع الغرب أن العقل بمنطقه العلمي والتجريبي يساعد على اكتشاف الظواهر الطبيعي ويساعد على التعرف على العلاقات وعلى الحقائق، بل ويساعد على تكوين العلاقات والنظريات، اعتمدوا عليه اعتماداً مطلقاً، وهمشوا القلب وعلومه الإنسانية، وعقلنوا علومهم المختلفة. وعقلنوا حياتهم وتعاملاتهم بل وعقلنوا مشاعرهم وأحاسيسهم معتمدين في ذلك على العقل وعلى منطقه العقلاني والعلمي والتجريبي، بل وأثروا وأشبعوا العقل بالمعلومات اللازمة له وبالأدوات الفكرية والمنطقية لتطويعه أكثر وأكثر ليعطي أكثر، فوضعوا له البرامج والمناهج العلمية المختلفة للتعرف عليه عن قرب، وللتعامل معه عن قرب وعن معرفة، لتطوير مهاراته وللاستفادة من قدراته التفكيرية ولمحاكاته. فتكونت لديهم مناعة عقلانية تجعلهم يرفضون في واقعهم وفي حياتهم ما لا يمنطق، وخاصة عندما يخرج عن العقل والعقلانية التي تنشأ عليها.
كل تلك العقلنة تحدث والإنسان الغربي - الذي يريد عقلنة العلوم وعقلنة كل شيء، غافل عن قلبه وعن علومه القلبية ومعرض عنه إلا من النواحي الصحية والعاطفية، ذلك تناقض عجيب وهو مكر وخداع مبرمج ودبر بليل وعقوبة ربانية وقع بها الغرب وسارت عليه أجيالهم ومن تبعهم.
فالغرب عندما عزل وفصل الدين عن النهضة الصناعية وعن الحياة الاجتماعية وعن التعاملات التجارية وعن العلاقات السياسية، يعلم أن العقل جهاز لا يحس ولا يشعر ولا يعرف المشاعر الإنسانية ولا يتعامل معها، ويعلم الغرب كذلك أن القلب هو الذي يحس ويشعر ويعي ويدرك وهو المسؤول عن التعامل مع تلك المشاعر الإنسانية، ويعلمون من كتبهم السماوية التي بين أيديهم أن القلب هو المسؤول عن الدين وعن الإيمان. فالدين يعني الإيمان بالله وبرسله والإيمان باليوم الآخر، والإيمان هو التصديق وهو حب ومشاعر وأحاسيس وهو تفاعلات وتعاملات إنسانية، والحب محله القلب وليس العقل، لذلك جاءت المناهج الغربية عقلانية بحتة متجردة من الإيمان ومتجردة من الإنسانية، تمجد العقل للعبث تحت شعار رفاه الإنسانية، بينما هي تحارب الإيمان وتعادي القلب وتدمره وتقتل في الإنسان مشاعره وأحاسيسه الإنسانية.
ثم يأتي السؤال القلب الذي همشه الغرب كيف يفكر؟
لا شك أن الإيمان والأخلاق والمشاعر والأحاسيس الإنسانية محلها القلب وهي عمله ووظيفته. فالجبن والخوف والشجاعة والجرأة والحياء كلها من وظائف ومن أعمال القلب وليست من وظائف العقل والمنطق، وكذلك البخل والكرم، وكذلك الحب بكل أنواعه ودرجاته وألوانه وكذلك الكره والحقد والبغض، والقلب هو الذي يصدق وبقوة الإيمان الشؤون العامة التي تهم حياة كل مواطن من النواحي المعنوية والمادية، ففي الجوانب الشخصية الخاصة والخاصة جداً تجد أن المواطن حريص على مصالحه المختلفة، وفي المواقف الوطنية تجد أن المواطن يفتخر بوطنيته ويفتخر بسياسة وطنه وحريص على السياسة التي تنمي مصالحه وتدعمه وتشجع عنده ذلك الاتجاه.
ماذا ينتج عن احتكار بعض العلوم العامة؟
لا شك أن احتكار العلوم العامة مثل علوم السياسة خطأ كبير وخطره عظيم على كل المستويات وعلى جميع المجالات، فهو يولد تخلفاً وإعاقة وسلبيات علمية وإدارية وسياسية عظيمة تتضاعف مع الزمن، وهو دليل تناقض تعليمي وسياسي كبيرين. وكلما كان الاحتكار إرهابياً كلما كان الهروب الفكري والعلمي والثقافي من الساحة السياسية أكبر. فيضمر بل ينعدم التطور النظري والعلمي في الساحة السياسية، وينتج الجمود، وتشل الحركة الفكرية وتضيق مساحة الحرية والحركة فيصبح الدوران في ساحة فارغة من جهة ومغلقة من الجهة الأخرى ويكون سقفها محدوداً بعادات وتقاليد مجترة ومورثة وجامدة، فتأتي التبعية والقوقعة. ومن هنا يتبين أن التعامل الإرهابي مع الشأن السياسي يقتل الحرية والسببية ويقتل غريزة الاعتزاز عند المواطن ويضاعف عنده الخوف والحذر السلبي، أي عدم الإخلاص.
لذلك يجب تعميم العام، وبالطريقة المناسبة التي تليق به. فالسياسة من العلوم الاجتماعية العامة التي يمكن - بل يجب - منهجتها والتدرج في تعليمها ومن المراحل الابتدائية الأولى وإلى المراحل الجامعية. مثل هذا التوجّه يحدث نقلة نوعية آنية، نحن في أمس الحاجة لها، إذ إن السياسة تعلم الطالب كيف يفهم الواقع الذي يحيط به فهماً صحيحاً مستمداً من الكتاب والسنة، ثم تعده وتجهزه لمواجهة الواقع، وليس الهروب منه، فتعلمه الأدوات العلمية والفكرية أي كيف يتعامل مع الواقع بطريق علمية سليمة ومدروسة، فيتكون عنده مناعة حضارية، فلا يقبل الواقع كمسلمات ثابتة - مقدسة أو موروثة - لا يمكن - ولا يجوز - تغيرها أو التعامل معها، بل يسأل ويناقش ويحاور، ويتدرج كذلك بتعلمه أدوات البحث والتفكير والسؤال والتي تساعده على التدرج في فهم والتعامل مع هذا الواقع فهماً منظماً وسليماً، ويتدرب نظرياً وعملياً عليها.
والواقع يشمل الحياة الفردية والاجتماعية كما يشمل الطبيعة المحيطة، فمعرفة الواقع فهماً صحيحاً يتضمن معرفة مكوناته ومحتوياته وآلياته وأدواته
كثر الحديث في الحضارة الغربية المعاصرة عن العقل وعن المنطق، حتى أصبح الاعتماد عليه وعلى علومه العقلية والمنطقية هو المقياس الذي يقاس به تقدم الأفراد والشعوب والأمم في النهضة العلمية والصناعية والتقنية، بل وحتى في وجود ورقي المشاعر الإنسانية وعن دوره في رقي الإنسان ونهضته وتطوره، حتى كأن القلب غير موجود وأنه ليس له دور يذكر. همشوا قلوبهم والقلب هو الإنسان.
من الجانب المادي اهتموا بالعقل والمنطق، والعقل، كما هو متعارف عليه عالمياً، هو جهاز التفكير والتحليل عند الإنسان وهو المسؤول عن المنطق، ويقصد بالمنطق هنا حسن الفهم للمواضيع والاستشكال، ولا يقصد بالمنطق هنا النطق والكلام والتعبير، وإن كان النطق التعبير الصحيح هو المطلوب ولكن يقصد بالمنطق طريقة التفكير وطريقة ترتيب وتسلسل الأفكار والحجج والأدلة المناسبة التي يستشهد بها للإيضاح أو للاستنتاج أو لإثبات موضوع ما.
ولما اقتنع الغرب أن العقل بمنطقه العلمي والتجريبي يساعد على اكتشاف الظواهر الطبيعي ويساعد على التعرف على العلاقات وعلى الحقائق، بل ويساعد على تكوين العلاقات والنظريات، اعتمدوا عليه اعتماداً مطلقاً، وهمشوا القلب وعلومه الإنسانية، وعقلنوا علومهم المختلفة. وعقلنوا حياتهم وتعاملاتهم بل وعقلنوا مشاعرهم وأحاسيسهم معتمدين في ذلك على العقل وعلى منطقه العقلاني والعلمي والتجريبي، بل وأثروا وأشبعوا العقل بالمعلومات اللازمة له وبالأدوات الفكرية والمنطقية لتطويعه أكثر وأكثر ليعطي أكثر، فوضعوا له البرامج والمناهج العلمية المختلفة للتعرف عليه عن قرب، وللتعامل معه عن قرب وعن معرفة، لتطوير مهاراته وللاستفادة من قدراته التفكيرية ولمحاكاته. فتكونت لديهم مناعة عقلانية تجعلهم يرفضون في واقعهم وفي حياتهم ما لا يمنطق، وخاصة عندما يخرج عن العقل والعقلانية التي تنشأ عليها.
كل تلك العقلنة تحدث والإنسان الغربي - الذي يريد عقلنة العلوم وعقلنة كل شيء، غافل عن قلبه وعن علومه القلبية ومعرض عنه إلا من النواحي الصحية والعاطفية، ذلك تناقض عجيب وهو مكر وخداع مبرمج ودبر بليل وعقوبة ربانية وقع بها الغرب وسارت عليه أجيالهم ومن تبعهم.
فالغرب عندما عزل وفصل الدين عن النهضة الصناعية وعن الحياة الاجتماعية وعن التعاملات التجارية وعن العلاقات السياسية، يعلم أن العقل جهاز لا يحس ولا يشعر ولا يعرف المشاعر الإنسانية ولا يتعامل معها، ويعلم الغرب كذلك أن القلب هو الذي يحس ويشعر ويعي ويدرك وهو المسؤول عن التعامل مع تلك المشاعر الإنسانية، ويعلمون من كتبهم السماوية التي بين أيديهم أن القلب هو المسؤول عن الدين وعن الإيمان. فالدين يعني الإيمان بالله وبرسله والإيمان باليوم الآخر، والإيمان هو التصديق وهو حب ومشاعر وأحاسيس وهو تفاعلات وتعاملات إنسانية، والحب محله القلب وليس العقل، لذلك جاءت المناهج الغربية عقلانية بحتة متجردة من الإيمان ومتجردة من الإنسانية، تمجد العقل للعبث تحت شعار رفاه الإنسانية، بينما هي تحارب الإيمان وتعادي القلب وتدمره وتقتل في الإنسان مشاعره وأحاسيسه الإنسانية.
ثم يأتي السؤال القلب الذي همشه الغرب كيف يفكر؟
لا شك أن الإيمان والأخلاق والمشاعر والأحاسيس الإنسانية محلها القلب وهي عمله ووظيفته. فالجبن والخوف والشجاعة والجرأة والحياء كلها من وظائف ومن أعمال القلب وليست من وظائف العقل والمنطق، وكذلك البخل والكرم، وكذلك الحب بكل أنواعه ودرجاته وألوانه وكذلك الكره والحقد والبغض، والقلب هو الذي يصدق وبقوة الإيمان الشؤون العامة التي تهم حياة كل مواطن من النواحي المعنوية والمادية، ففي الجوانب الشخصية الخاصة والخاصة جداً تجد أن المواطن حريص على مصالحه المختلفة، وفي المواقف الوطنية تجد أن المواطن يفتخر بوطنيته ويفتخر بسياسة وطنه وحريص على السياسة التي تنمي مصالحه وتدعمه وتشجع عنده ذلك الاتجاه.
ماذا ينتج عن احتكار بعض العلوم العامة؟
لا شك أن احتكار العلوم العامة مثل علوم السياسة خطأ كبير وخطره عظيم على كل المستويات وعلى جميع المجالات، فهو يولد تخلفاً وإعاقة وسلبيات علمية وإدارية وسياسية عظيمة تتضاعف مع الزمن، وهو دليل تناقض تعليمي وسياسي كبيرين. وكلما كان الاحتكار إرهابياً كلما كان الهروب الفكري والعلمي والثقافي من الساحة السياسية أكبر. فيضمر بل ينعدم التطور النظري والعلمي في الساحة السياسية، وينتج الجمود، وتشل الحركة الفكرية وتضيق مساحة الحرية والحركة فيصبح الدوران في ساحة فارغة من جهة ومغلقة من الجهة الأخرى ويكون سقفها محدوداً بعادات وتقاليد مجترة ومورثة وجامدة، فتأتي التبعية والقوقعة. ومن هنا يتبين أن التعامل الإرهابي مع الشأن السياسي يقتل الحرية والسببية ويقتل غريزة الاعتزاز عند المواطن ويضاعف عنده الخوف والحذر السلبي، أي عدم الإخلاص.
لذلك يجب تعميم العام، وبالطريقة المناسبة التي تليق به. فالسياسة من العلوم الاجتماعية العامة التي يمكن - بل يجب - منهجتها والتدرج في تعليمها ومن المراحل الابتدائية الأولى وإلى المراحل الجامعية. مثل هذا التوجّه يحدث نقلة نوعية آنية، نحن في أمس الحاجة لها، إذ إن السياسة تعلم الطالب كيف يفهم الواقع الذي يحيط به فهماً صحيحاً مستمداً من الكتاب والسنة، ثم تعده وتجهزه لمواجهة الواقع، وليس الهروب منه، فتعلمه الأدوات العلمية والفكرية أي كيف يتعامل مع الواقع بطريق علمية سليمة ومدروسة، فيتكون عنده مناعة حضارية، فلا يقبل الواقع كمسلمات ثابتة - مقدسة أو موروثة - لا يمكن - ولا يجوز - تغيرها أو التعامل معها، بل يسأل ويناقش ويحاور، ويتدرج كذلك بتعلمه أدوات البحث والتفكير والسؤال والتي تساعده على التدرج في فهم والتعامل مع هذا الواقع فهماً منظماً وسليماً، ويتدرب نظرياً وعملياً عليها.
والواقع يشمل الحياة الفردية والاجتماعية كما يشمل الطبيعة المحيطة، فمعرفة الواقع فهماً صحيحاً يتضمن معرفة مكوناته ومحتوياته وآلياته وأدواته