محمد الفاتح
محمد الفاتح
محمد الفاتح
السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح (بالتركية العثمانية: فاتح سلطان محمد خان ثاني؛ بالتركية: Fatih Sultan Mehmed II أو II. Mehmed) والذي عُرف في أوروبا خلال عصر النهضة باسم "Mahomet II"، أي ذات اللفظ الذي كان الأوربيون يلفظون به اسم نبي الإسلام،[3][4] هو سابع سلاطين الدولة العثمانية وسلالة آل عثمان، يُلقب، إلى جانب "الفاتح"، بأبي الفتوح وأبو الخيرات، وبعد فتح القسطنطينية أضيف لقب "قيصر" إلى ألقابه وألقاب باقي السلاطين الذين تلوه.[5] حكم ما يقرب من ثلاثين عامًا عرفت توسعًا كبيرًا للخلافة الإسلامية.
يُعرف هذا السلطان بأنه هو من قضى نهائيًا على الإمبراطورية البيزنطية بعد أن استمرّت أحد عشر قرنًا ونيفًا، ويعتبر الكثير من المؤرخين هذا الحدث خاتمة العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة،[6][7] وعند الأتراك فهذا الحدث هو "فاتحة عصر الملوك" (بالتركية: çağ açan hükümdar).
تابع السلطان محمد فتوحاته في آسيا، فوحّد ممالك الأناضول، وتوغّل في أوروبا حتى بلغراد. من أبرز أعماله الإدارية دمجه للإدارات البيزنطية القديمة في جسم الدولة العثمانية المتوسعة آنذاك. يُلاحظ أن محمد الثاني لم يكن أول حاكم تركي للقسطنطينية، فقد كان أحد الأباطرة الروم السابقين، والمدعو "ليون الرابع" (باليونانية: Λέων Δ΄) من أصول خزرية، وهؤلاء قوم من الترك شبه رحّل كانوا يقطنون سهول شمال القوقاز. كان محمد الثاني عالي الثقافة ومحبًا للعلم والعلماء، وقد تكلّم عدداً من اللغات إلى جانب اللغة التركية، وهي: الفرنسية، اللاتينية، اليونانية، الصربية، الفارسية، العربية، والعبرية
بداية حياته
إخبار نبي الإسلام عنه
يؤمن المسلمون بأن النبي محمد بن عبد الله تحدث عن أمير من أفضل أمراء العالم، وأنه هو من سيفتح القسطنطينية ويُدخلها ضمن الدولة الإسلامية، فقد ورد في مسند أحمد بن حنبل في الحديث رقم 18189:

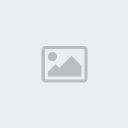
رسم بيد السلطان محمد الثاني مأخوذ من كتاب رسوماته عندما كان صبيّا، وتظهر في الأعلى طغرائه المكونة من حروف متشابكة.
وُلد محمد الثاني، للسلطان "مراد الثاني" و"هما خاتون"،[1][11] فجر يوم الأحد بتاريخ 20 أبريل، 1429 م، الموافق في 26 رجب سنة 833 هـ في مدينة أدرنة، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك.[12] عندما بلغ محمد الثاني ربيعه الحادي عشر أرسله والده السلطان إلى أماسيا ليكون حاكمًا عليها وليكتسب شيئًا من الخبرة اللازمة لحكم الدولة، كما كانت عليه عادة الحكّام العثمانيين قبل ذلك العهد. فمارس محمد الأعمال السلطانية في حياة أبيه، ومنذ تلك الفترة وهو يعايش صراع الدولة البيزنطية في الظروف المختلفة، كما كان على اطلاع تام بالمحاولات العثمانية السابقة لفتح القسطنطينية، بل ويعلم بما سبقها من محاولات متكررة في العصور الإسلامية المختلفة.[13] وخلال الفترة التي قضاها حاكماً على أماسيا، كان السلطان مراد الثاني قد أرسل إليه عددًا من المعلمين لكنه لم يمتثل لأمرهم، ولم يقرأ شيئاً، حتى أنه لم يختم القرآن الكريم، الأمر الذي كان يُعد ذا أهمية كبرى، فطلب السلطان المذكور، رجلاً له مهابةٌ وحدّة، فذكر له المولى "أحمد بن إسماعيل الكوراني"، فجعله معلمًا لولده وأعطاه قضيبًا يضربه به إذا خالف أمره، فذهب إليه، ودخل عليه والقضيب بيده، فقال: "أرسلني والدك للتعليم والضرب إذا خالفت أمري"، فضحك السلطان محمد الثاني من ذلك الكلام، فضربه المولى الكوراني في ذلك المجلس ضربًا شديدًا، حتى خاف منه السلطان محمد، وختم القرآن في مدة يسيرة.[14]
هذه التربية الإسلامية كان لها الأثر الأكبر في تكوين شخصية محمد الفاتح، فجعلته مسلمًا مؤمنًا ملتزمًا بحدود الشريعة، مقيدًا بالأوامر والنواهي، معظمًا لها ومدافعًا عن إجراءات تطبيقها، فتأثر بالعلماء الربانيين، وبشكل خاص معلمه المولى "الكوراني" وانتهج منهجهم.[15] وبرز دور الشيخ "آق شمس الدين" في تكوين شخصية محمد الفاتح وبث فيه منذ صغره أمرين هما: مضاعفة حركة الجهاد العثمانية، والإيحاء دومًا لمحمد منذ صغره بأنه الأمير المقصود بالحديث النبوي، لذلك كان الفاتح يطمع أن ينطبق عليه حديث نبي الإسلام.
اعتلاؤه العرش للمرة الأولى وتنازله عنه

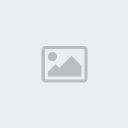
السلطان مراد الثاني، والد السلطان محمد الفاتح.

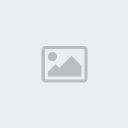
معركة فارنا، بريشة "يان ماتيكو".
في 13 يوليو سنة 1444 م، الموافق 26 ربيع الأول سنة 848 هـ، أبرم السلطان مراد الثاني معاهدة سلام مع إمارة قرمان بالأناضول، وعقب ذلك توفي أكبر أولاد السلطان واسمه علاء الدين، فحزن عليه والده حزنًا شديدًا وسئم الحياة،[16][17] فتنازل عن الملك لابنه محمد البالغ من العمر أربع عشرة سنة، وسافر إلى ولاية أيدين للإقامة بعيدًا عن هموم الدنيا وغمومها.[18] لكنه لم يمكث في خلوته بضعة أشهر حتى أتاه خبر غدر المجر وإغارتهم على بلاد البلغار غير مراعين شروط الهدنة اعتمادًا على تغرير الكاردينال "سيزاريني"، مندوب البابا، وإفهامه لملك المجر أن عدم رعاية الذمة والعهود مع المسلمين لا تُعد حنثًا ولا نقضًا.[18]
وكان السلطان محمد الثاني قد كتب إلى والده يطلب منه العودة ليتربع على عرش السلطنة تحسبًا لوقوع معركة مع المجر، إلا أن مراد رفض هذا الطلب. فرد محمد الثاني الفاتح : "إن كنت أنت السلطان فتعال وقف على قيادة جيشك ورياسة دولتك وإن كنت أنا السلطان فإني آمرك بقيادة الجيش". وبناءً على هذه الرسالة، عاد السلطان مراد الثاني وقاد الجيش العثماني في معركة فارنا، التي كان فيها النصر الحاسم للمسلمين بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1444 م، الموافق في 28 رجب سنة 848 هـ.[19]
يُقال بأن عودة السلطان مراد الثاني إلى الحكم كان سببها أيضًا الضغط الذي مارسه عليه الصدر الأعظم "خليل باشا"، الذي لم يكن مولعًا بحكم محمد الثاني، بما أن الأخير كان متأثرًا بمعلمه المولى "الكوراني" ويتخذ منه قدوة، وكان الكوراني على خلاف مع الباشا.
الفترة في مانيسا (1446-1451)

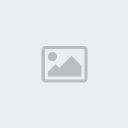
موقع مانيسا في تركيا.
انتقل السلطان محمد الثاني إلى مانيسا الواقعة بغرب الأناضول بعد ثورة الإنكشارية عليه، وبعد أن جمعهم والده وانتقل لخوض حروبه في أوروبا. ليس هناك من معلومات كثيرة تفيد بالذي قام به السلطان محمد في الفترة التي قضاها في مدينة مانيسا، ولكن يُعرف أنه خلال هذه الفترة، تزوج السلطان بوالدة ولي العهد، كما كان يُطلق على زوجات السلاطين، "أمينة گلبهار" ذات الجذور اليونانية النبيلة،[20] من قرية "دوفيرا" في طرابزون،[20] والتي توفيت بعد ذلك عام 1492 بعد أن أنجبت السلطان بايزيد الثاني.[21] وكان السلطان مراد الثاني قد عاد إلى عزلته مرة أخرى بعد أن انتصر على المجر واستخلص مدينة فارنا منهم، لكنه لم يلبث فيها هذه المرة أيضا، لأن عساكر الإنكشارية ازدروا ملكهم الفتى محمد الثاني وعصوه ونهبوا مدينة أدرنة عاصمة الدولة، فرجع إليهم السلطان مراد الثاني في أوائل سنة 1445 وأخمد فتنتهم. وخوفًا من رجوعهم إلى إقلاق راحة الدولة، أراد أن يشغلهم بالحرب، فأغار على بلاد اليونان والصرب طيلة سنواته الباقية، وفتح عددًا من المدن والإمارات وضمها إلى الدولة العثمانية.[19] تزوج السلطان محمد في هذه الفترة أيضا بزوجته الثانية "ستّي مكرم خاتون" الأميرة من سلالة ذي القدر التركمانية.[22][23]
قام محمد الفاتح خلال المدة التي قضاها في مانيسا، بضرب النقود السلجوقية باسمه،[24] وفي أغسطس أو سبتمبر من عام 1449، توفيت والدته،[25] وبعد هذا بسنة، أي في عام 1450، أبرم والده صلحًا مع "اسكندر بك"، أحد أولاد "جورج كستريو" أمير ألبانيا الشمالية الذين كان السلطان مراد الثاني قد أخذهم رهائن وضمّ بلاد أبيهم إليه بعد موته. وكان اسكندر المذكور قد أسلم، أو بالأحرى تظاهر بالإسلام لنوال ما يكنه صدره وأظهر الإخلاص للسلطان حتى قرّبه إليه، ثم انقلب عليه أثناء انشغاله بمحاربة الصرب والمجر، وبعد عدد من المعارك لم يستطع الجيش العثماني المنهك استرجاع أكثر من مدينتين ألبانيتين،[26] فرأى السلطان مصالحة البك ريثما يعود ليستجمع جيشه قوته ثم يعود لفتح مدينة "آق حصار".[
اعتلاؤه العرش للمرة الثانية وفتح القسطنطينية

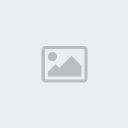
الدولة العثمانية والدول والإمارات المحيطة بها عام 1450، أي قبل تربّع محمد الثاني على العرش بسنة واحدة.
عاد السلطان مراد الثاني إلى أدرنة، عاصمة ممالكه ليُجهز جيوشًا جديدة كافية لقمع الثائر على الدولة، "اسكندر بك"، لكنه توفي في يوم 7 فبراير سنة 1451، الموافق في 5 محرم سنة 855هـ. وما أن وصلت أنباء وفاة السلطان إلى ابنه محمد الثاني، حتى ركب فوراً وعاد إلى أدرنة حيث توّج سلطانا للمرة الثانية في 19 فبراير من نفس العام،[29] وأقام جنازة لوالده الراحل وأمر بنقل الجثمان إلى مدينة بورصة لدفنه بها،[30] وأمر بإرجاع الأميرة "مارا" الصربية إلى والدها، أمير الصرب المدعو "جورج برنكوفيتش"، الذي زوّجها للسلطان مراد الثاني عندما أبرم معه معاهدة سلام قرابة عام 1428.[31][32]
عندما تولى محمد الثاني الملك بعد أبيه لم يكن بآسيا الصغرى خارجًا عن سلطانه إلا جزء من بلاد القرمان ومدينة "سينوب" ومملكة طرابزون الروميّة. وصارت مملكة الروم الشرقية قاصرة على مدينة القسطنطينية وضواحيها. وكان إقليم "موره" مجزءاً بين البنادقة وعدّة إمارات صغيرة يحكمها بعض أعيان الروم أو الإفرنج الذين تخلفوا عن إخوانهم بعد انتهاء الحروب الصليبية، وبلاد الأرنؤد وإيبيروس في حمى إسكندر بك سالف الذكر، وبلاد البشناق المستقلة، والصرب التابعة للدولة العثمانية تبعية سيادية، وما بقي من شبه جزيرة البلقان كان داخلاً تحت سلطة الدولة كذلك
الإعداد للفتح

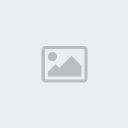
قلعة روملي حصار كما تبدو اليوم، كما يراها الناظر من مضيق البوسفور.
أخذ السلطان محمد الثاني، بعد وفاة والده، يستعد لتتميم فتح ما بقي من بلاد البلقان ومدينة القسطنطينية حتى تكون جميع أملاكه متصلة لا يتخللها عدو مهاجم أو صديق منافق، فبذل بداية الأمر جهودًا عظيمة في تقوية الجيش العثماني بالقوى البشرية حتى وصل تعداده إلى قرابة ربع مليون جندي، وهذا عدد كبير مقارنة بجيوش الدول في تلك الفترة، كما عني عناية خاصة بتدريب تلك الجموع على فنون القتال المختلفة وبمختلف أنواع الأسلحة التي تؤهلهم للغزو الكبير المنتظر، كما أعتنى الفاتح بإعدادهم إعدادًا معنويًا قويًا وغرس روح الجهاد فيهم، وتذكيرهم بثناء النبي محمد على الجيش الذي يفتح القسطنطينية وعسى أن يكونوا هم الجيش المقصود بذلك، مما أعطاهم قوة معنوية وشجاعة منقطعة النظير، كما كان لانتشار العلماء بين الجنود أثر كبير في تقوية عزائمهم.[31]
أراد السلطان، قبل أن يتعرض لفتح القسطنطينية أن يُحصّن مضيق البوسفور حتى لا يأتي لها مدد من مملكة طرابزون، وذلك بأن يُقيم قلعة على شاطئ المضيق في أضيق نقطة من الجانب الأوروبي منه مقابل القلعة التي أسست في عهد السلطان بايزيد في البر الآسيوي.[33] ولمّا بلغ إمبراطور الروم هذا الخبر أرسل إلى السلطان سفيرًا يعرض عليه دفع الجزية التي يُقررها،[31] فرفض الفاتح طلبه وأصر على البناء لما يعلمه من أهمية عسكرية لهذا الموقع، حتى اكتملت قلعة عالية ومحصنة، وصل ارتفاعها إلى 82 مترًا، وأطلق عليها اسم "قلعة روملي حصار" (بالتركية: Rumeli Hisarı)، وأصبحت القلعتان متقابلتين، ولا يفصل بينهما سوى 660 مترًا، تتحكمان في عبور السفن من شرقي البوسفور إلى غربه وتستطيع نيران مدافعهما منع أية سفينة من الوصول إلى القسطنطينية من المناطق التي تقع شرقها مثل مملكة طرابزون وغيرها من الأماكن التي تستطيع دعم المدينة عند الحاجة.[33] كما فرض السلطان رسومًا على كل سفينة تمر في مجال المدافع العثمانية المنصوبة في القلعة، وكان أن رفضت إحدى سفن البندقية أن تتوقف بعد أن أعطى العثمانيون لها عدداً من الإشارات، فتمّ إغراقها بطلقة مدفعية واحدة فقط.[34]

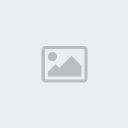
مدفع سلطاني عثماني مماثل للمدفع الذي استخدم عند حصار القسطنطينية. تمّ صب هذا المدفع عام 1464، وهو الآن موجود في متحف الترسانة الملكية البريطانية.
اعتنى السلطان عناية خاصة بجمع الأسلحة اللازمة لفتح القسطنطينية، ومن أهمها المدافع، التي أخذت اهتمامًا خاصًا منه حيث أحضر مهندسًا مجريًا يدعى "أوربان" كان بارعًا في صناعة المدافع، فأحسن استقباله ووفر له جميع الإمكانيات المالية والمادية والبشرية. تمكن هذا المهندس من تصميم وتصنيع العديد من المدافع الضخمة كان على رأسها "المدفع السلطاني" المشهور، والذي ذكر أن وزنه كان يصل إلى مئات الأطنان وأنه يحتاج إلى مئات الثيران القوية لتحريكه، وقد أشرف السلطان بنفسه على صناعة هذه المدافع وتجريبها.[35]
ويُضاف إلى هذا الاستعداد ما بذله الفاتح من عناية خاصة بالأسطول العثماني؛ حيث عمل على تقويته وتزويده بالسفن المختلفة ليكون مؤهلاً للقيام بدوره في الهجوم على القسطنطينية، تلك المدينة البحرية التي لا يكمل حصارها دون وجود قوة بحرية تقوم بهذه المهمة وقد ذُكر أن السفن التي أعدت لهذا الأمر بلغت أكثر من أربعمائة سفينة،[36] بينما قال آخرون أن هذا الرقم مبالغ فيه وأن عدد السفن كان أقل من ذلك، حيث بلغت مائة وثمانين سفينة في الواقع
عقد معاهدات
عمل الفاتح قبل هجومه على القسطنطينية على عقد معاهدات مع أعدائه المختلفين ليتفرغ لعدو واحد، فعقد معاهدة مع إمارة غلطة المجاورة للقسطنطينية من الشرق ويفصل بينهما مضيق القرن الذهبي، كما عقد معاهدات مع جنوة والبندقية وهما من الإمارات الأوروبية المجاورة، ولكن هذه المعاهدات لم تصمد حينما بدأ الهجوم الفعلي على القسطنطينية، حيث وصلت قوات من تلك المدن وغيرها للمشاركة في الدفاع عن المدينة.[37]
في هذه الأثناء التي كان السلطان يعد العدة فيها للفتح، استمات الإمبراطور البيزنطي في محاولاته لثنيه عن هدفه، بتقديم الأموال والهدايا المختلفة إليه، وبمحاولة رشوة بعض مستشاريه ليؤثروا على قراره،[38] ولكن السلطان كان عازمًا على تنفيذ مخططه ولم تثنه هذه الأمور عن هدفه، ولما رأى الإمبراطور البيزنطي شدة عزيمة السلطان على تنفيذ هدفه عمد إلى طلب المساعدات من مختلف الدول والمدن الأوروبية وعلى رأسها البابا زعيم المذهب الكاثوليكي، في الوقت الذي كانت فيه كنائس الدولة البيزنطية وعلى رأسها القسطنطينية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية وكان بينهما عداء شديد، وقد اضطر الإمبراطور لمجاملة البابا بأن يتقرب إليه ويظهر له استعداده للعمل على توحيد الكنيستين الشرقية والغربية،[39] في الوقت الذي لم يكن الأرثوذكس يرغبون في ذلك. قام البابا بناءً على ذلك بإرسال مندوب منه إلى القسطنطينية، خطب في كنيسة آيا صوفيا ودعا للبابا وأعلن توحيد الكنيستين، مما أغضب جمهور الأرثوذكس في المدينة، وجعلهم يقومون بحركة مضادة لهذا العمل الإمبراطوري الكاثوليكي المشترك، حتى قال بعض زعماء الأرثوذكس: "إنني أفضل أن أشاهد في ديار البيزنط عمائم الترك على أن أشاهد القبعة اللاتينية".[













